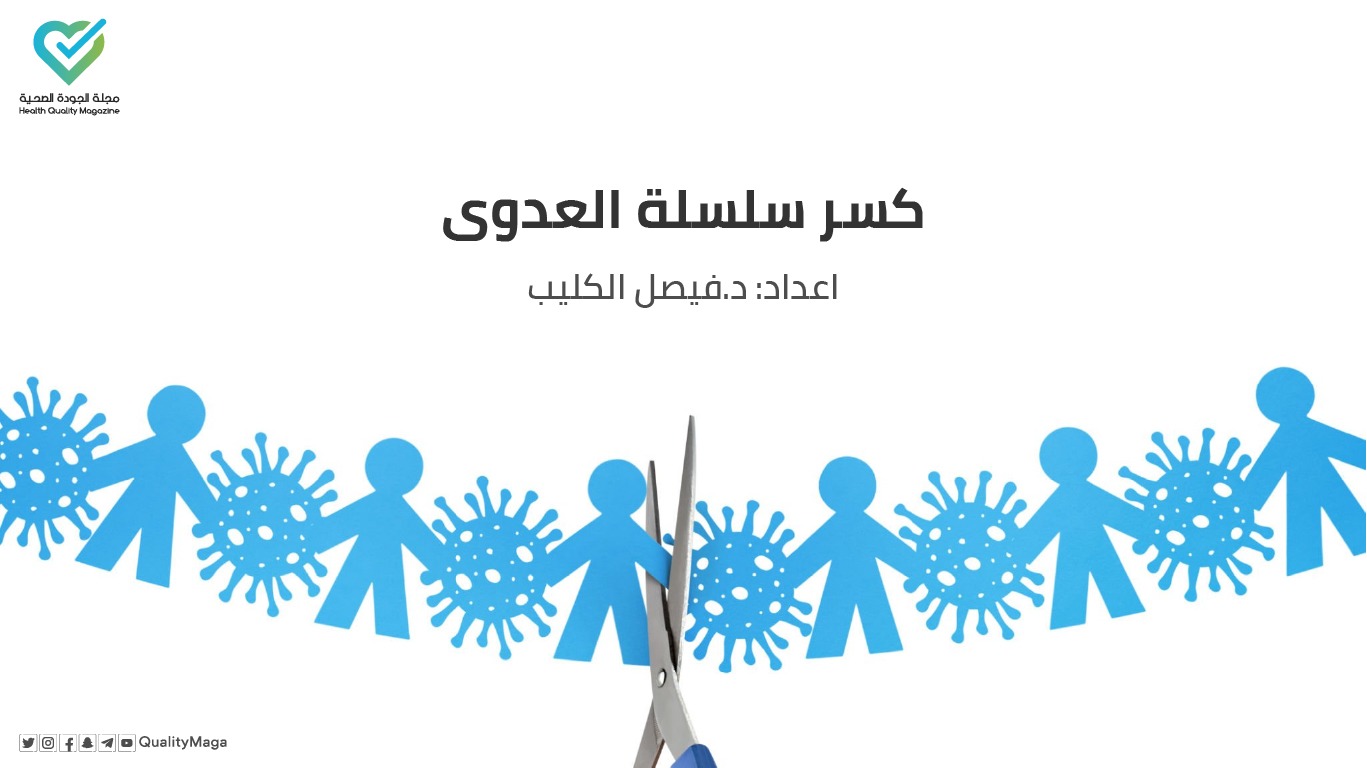معايير برادفورد هيل (Bradford Hill’s Criteria)
معايير برادفورد هيل (Bradford Hill’s Criteria)
إعداد: د. فيصل الكليب
في عام 1965أقترح عالم الوبائيات أرستن برادفورد معايير لتحديد العلاقة السببية بين عامل معين و مرض معين؛ لكي تساعد الباحثيين في التمييز بين الارتباط والسببية، ولا يجب أن تكون متوفرة جميعها لإثبات السببية، ولكن كلما توفرت، زادت قوة الدليل على أن العامل مسبب وليس مجرد ارتباط. هذه المعايير تسمى
معايير برادفورد هيل (Bradford Hill’s Criteria)؛ وهي كالتالي:-
1.القوة: كلما كان الارتباط بين العامل والمرض أقوى، زادت احتمالية أن يكون العامل سببًا في المرض.
2.التناسق: إذا تم ملاحظة العلاقة نفسها في دراسات بحثية متعددة و أماكن مختلفة، وعلى فئات سكانية مختلفة، فهذا يعزز الدليل على السببية.
3.الخصوصية: إذا كان العامل مرتبطًا بمرض معين فقط وليس بأمراض متعددة، فهذا يزيد من احتمالية كونه سببًا مباشرًا لهذا المرض.
4.التسلسل الزمني: يجب أن يسبق العامل المسبب ظهور المرض، فلا يمكن أن يكون سببًا لمرض إذا جاء بعده.
5.الجرعة والاستجابة: كلما زادت جرعة التعرض للعامل، زاد خطر الإصابة بالمرض.
6.المعقولية: يجب أن يكون هناك تفسير علمي منطقي يوضح كيف يمكن أن يؤدي العامل إلى المرض.
7.الاتساق مع الأدلة العلمية: يجب أن تتماشى العلاقة مع الأدلة العلمية عن المرض.
8.التجربة: إذا كان تقليل التعرض للعامل يؤدي إلى انخفاض معدلات المرض.
9.التشابه: إذا كان هناك عوامل أخرى تسبب أمراضًا مشابهة، فمن المنطقي افتراض أن العامل الجديد قد يكون له تأثير مشابه.
في مثال على تطبيق معايير برادفورد هيل في تأثير تحسين جودة الرعاية الصحية على معدلات الوفيات في المستشفيات. يكون التطبيق بحيث يشمل جميع المعايير:
القوة: تظهر الدراسات أن المستشفيات التي تتبنى معايير جودة أعلى (مثل الحصول على الاعتماد الصحي، وتقليل الأخطاء الطبية) لديها انخفاض ملحوظ في معدلات الوفيات مقارنة بالمستشفيات التي لا تطبق هذه المعايير.
التناسق: تم إثبات العلاقة في دراسات متعددة عبر دول العالم، حيث وجد أن تحسين جودة الرعاية يؤدي إلى انخفاض معدلات الوفيات وتحسن نتائج المريض
الخصوصية: تحسين الجودة يؤدي إلى نتائج محددة مثل تقليل الأخطاء الطبية، وتحسين الالتزام بالإجراءات العلاجية، مما يؤدي مباشرةً إلى تقليل الوفيات، بدلاً من التأثير على جميع المشاكل الصحية بشكل عام.
التسلسل الزمني: الدراسات توضح أن تطبيق برامج تحسين الجودة يسبق انخفاض الوفيات، مما يشير إلى علاقة سببية وليست مجرد ارتباط.
الإستجابة: كلما زاد العمل في تحسين جودة الرعاية (مثل تقليل عدد المرضى لكل ممرض، وتطبيق بروتوكولات مكافحة العدوى)، زاد التحسن في النتائج الصحية وانخفضت الوفيات.
المعقولية: بحيث هناك تفسير علمي ومنطقي يدعم العلاقة، حيث تؤدي تحسينات الجودة إلى تقليل الأخطاء الطبية، تحسين الالتزام بالعلاج، وتقليل المضاعفات، مما يقلل من الوفيات.
الاتساق مع الأدلة العلمية: تتماشى النتائج مع المعرفة الطبية الحالية التي تؤكد أن الأخطاء الطبية والعدوى المكتسبة في المستشفيات من الأسباب الرئيسية للوفيات القابلة للتدخل.
التجربة: سواءاً بشكل عشوائي أو لا؛ التجارب أظهرت أن التدخلات التي تركز على تحسين الجودة، مثل تدريب الطاقم الطبي وتقليل نسب العدوى، تؤدي إلى تقليل الوفيات وتحسين النتائج السريرية.
التشابه: كما أن تحسين جودة الرعاية في مجالات أخرى (مثل تقليل الأخطاء في الجراحة أو تحسين إدارة الأدوية) يؤدي إلى تقليل المضاعفات، فمن المنطقي أن تحسين الجودة بشكل عام سيؤدي إلى نتائج إيجابية مماثلة.
النتيجة استنادًا إلى معايير برادفورد هيل، أن هناك أدلة قوية تدعم أن تحسين جودة الرعاية الصحية ليس مجرد عامل مرتبط بتحسين النتائج، بل هو سبب مباشر في تقليل معدلات الوفيات في المستشفيات.
المراجع:
- Hill, A.B., 1965. The environment and disease: association or causation?. Proceedings of the Royal Society of Medicine, 58(5), pp.295-300.
- Institute of Medicine (IOM), 2001. Crossing the quality chasm: A new health system for the 21st century. Washington, DC: National Academy Press.
- Leape, L.L. and Berwick, D.M., 2005. Five years after To Err Is Human: what have we learned?. JAMA, 293(19), pp.2384-2390.
- Pronovost, P.J., Needham, D.M., Berenholtz, S.M., Sinopoli, D.J., Chu, H., Cosgrove, S.E., Sexton, J.B., Hyzy, R., Welsh, R., Roth, G. and Bander, J., 2006. An intervention to decrease catheter-related bloodstream infections in the ICU. New England Journal of Medicine, 355(26), pp.2725-2732.
- Shojania, K.G. and Grimshaw, J.M., 2005. Evidence-based quality improvement: the state of the science. Health Affairs, 24(1), pp.138-150.